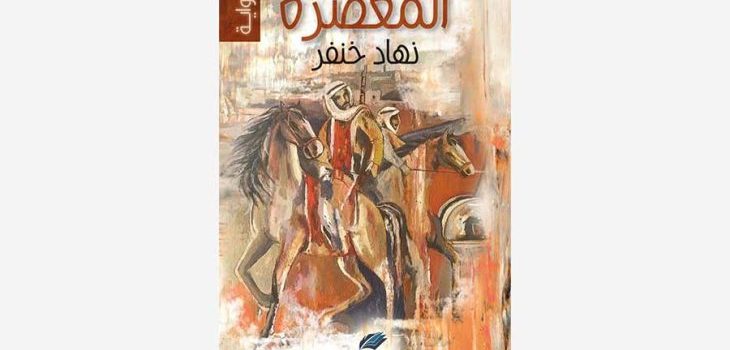محمد عبدالرحيم
بعدما ضاق الواقع بتفاصيل ومصير القضية الفلسطينية، أصبح الأدب أو الفن عموماً مجالاً خصباً لتناولها من زوايا عدة، وحسب موهبة وقدرات كل كاتب وفنان في صياغة هذه المأساة. فلن تنعدم الكتابات، حتى لو حلمنا بحل هذه المعضلة، التي نأمل أن تصبح الكتابة عنها من قبيل المرحلة التاريخية، التي نتذكرها حتى لا ننسى ونعيشها ثانية.
وتأتي رواية «المعصرة» للأكاديمي الفلسطيني نهاد خنفر، باحثة عن بدايات هذه المأساة، كيف تشكّلت وكيف أنتجت ثوارها والمدافعين عن هذه الأرض المغتصَبة، وبالضرورة الخونة الذين ساعدوا على ما أصبح عليه الوضع الراهن. تأتي البداية من انتهاء الحرب العالمية الأولى، وحتى نهاية ثلاثينيات القرن الفائت، أو ما عُرف بـ (الثورة الفلسطينية الكبرى) التي وقعت ما بين 1936 و1939، قبل بداية اندلاع الحرب العالمية الثانية، من خلال سرد الكاتب لتفاصيل تلك الفترة، والاستناد إلى حكايات ولمحات من حيوات شخصياتها الحقيقية، ناسجاً عبر شخصيتها الرئيسة أو بطلها شاهداً ومشاركاً في تلك الأحداث.
صدرت الرواية مؤخراً عن دار الشامل للنشر والتوزيع، نابلس/فلسطين، في ما يُقارب الـ500 صفحة.
مأساة إسماعيل
في الفصل الأول والمعنون بـ(زاوية من مسرح الرواية) يسرد خنفر حكاية ميلاد بطله (إسماعيل). ولنا الاستشهاد بهذا المقطع الافتتاحي، لأنه يعبّر عن أسلوب ورؤية الكاتب طوال الرواية.. «في الحَبْوِ الأول للزمن الزاحف قريباً من أعتابِ العشرينيات من القرن الماضي، وُلِدَ إسماعيل لزوجين مُفعمين بالحب، عبد الفتاح وخديجة، وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى حِمل أوزارها، بدأ يشق أشهره الأولى شاقاً عصا الحياة، حتى خفت عويل المدافع، وانقشع دخان البارود، وأعاد المنتصرون تقسيم العالم، فرسموا من الخرائط الجديدة ما رسموا، ومزقوا من قديمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
أعمَلَ جراحو الجغرافيا السياسية مشارطَهم في الأجساد المثخنة، يفتحون جرحاً هنا، ويخيطون جرحاً هناك، كيفما كان، غير آبهين بتعفن الجروح أو تقرّحها، ولا استمرار نزيفها أو تشويهها للأجساد، حتى لم يعد لعمليات الترميم فرصة لإصلاح الدولة/الجسد، أو إعادة نضارته. هكذا قُسّمت الأوطان وشُيّدت الحدود الوهمية على جسد الدولة العثمانية المريض المتهالك، وقطّعت أطرافه مباشرة بعد إعلان الوفاة».
هنا يتم سرد لحظة ميلاد بطل الرواية، مع الإحاطة بالجو العام والمناخ السياسي المصاحب لتلك اللحظة، الذي يطغى بشكل أو بآخر على الحدث الروائي. بمعنى أن الإسهاب في الوصف ـ مكان أو حالة ـ يعطل بشكل أو بآخر العملية السردية للحكاية، ناهيك من الرأي الشخصي للكاتب، والحاضر بقوة طوال الحكاية، فهو (الراوي العليم) عن شخصية جعلها بدوره وبالمصادفة (أسيرة) وجهة النظر الروائية. فمأساة (إسماعيل/البطل) وإن تحققت من خلال الوقائع السردية، إلا أنها تحققت من قبل متمثلة في أسلوب الكاتب نفسه.
تأتي رواية «المعصرة» للأكاديمي الفلسطيني نهاد خنفر، باحثة عن بدايات هذه المأساة، كيف تشكّلت وكيف أنتجت ثوارها والمدافعين عن هذه الأرض المغتصَبة، وبالضرورة الخونة الذين ساعدوا على ما أصبح عليه الوضع الراهن.
البناء الكلاسيكي
حاول الكاتب أن يختلق شخصية تتشابه مع الكثير من حالة الشخصيات المأزومة قدرياً، معتمداً على النموذج النمطي للشخصية الروائية، وكذا رحلة البطل المعهودة، من الفرار (الهجرة) ثم العودة مرّة أخرى، وبالطبع لا ينسى المؤلف سمات هذه الشخصية، يتيم صغير ضاقت به الدنيا، ففر باحثاً عن حياة أخرى، بداية من عمله في (المعصرة) وعشقه لابنة صاحب العمل، الذي يستغله لأقصى حد، نظير الطعام فقط وتوفير المأوى. ثم يتعرّف على أحد الثوار، الذي يثق به ويستأمنه، ثم يضمه إلى حركة المقاومة، فيكون الربط ما بين ما يحققه من انتصارات على العدو ـ الإنكليزي في الأساس ـ وما يريد تحقيقه على مستواه الشخصي، كمحاولة لتجاوز وضعه الاجتماعي والاقتصادي، ثم الإيقاع به وقضاء عدة سنوات في السجن، وهروبه وانضمامه للمقاومة مرّة أخرى، وقد أصبح ناراً على علم، لكن هذه السُمعة النضالية لم تشفع له عند عودته إلى صاحب المعصرة، وطلب يد ابنته، ليُذكّره الرجل بأنه في الأصل خادم لديهم لا أكثر ولا أقل، ولا يعني له النضال شيئاً، فالثروة والوضع الاجتماعي هما الأهم.
الماضي والراهن
حاول خنفر الكشف عن عِلة المأساة من خلال الفلسطينيين أنفسهم، وهي عِلة قديمة منذ نشأة الأزمة، وقد جاء بوجهة نظره على لسان الشاعر إبراهيم طوقان هذه المرّة، عندما سأله أحدهم عن رأيه عن الأحزاب السياسية الفلسطينية التي تشكّلت وقتها.. «بانت ابتسامةٌ خفيفة صنعها إبراهيم على وجهه، وأخذ نفسَاً عميقاً ثم نفثه، وكأن هموم الدنيا قد كبتَتْ أنفاسه! وقال ببعض الحُرقة: كم هو عدد الأحزاب الآن، ثلاثة أربعة؟ وربما يتم الإعلانُ عن المزيد، لكن صدقني كلما زادت الأحزاب ازداد انقسامُنا، وضعفُنا، وتشتّتَ الهدف، وسنخسرُ المعركة. الحركة الصهيونية تشجع اليهود وتغريهم بالهجرة إلى فلسطين وسرقة أرضها وقتل سكانها واحتلالها إلى ما لا نهاية، يقولون لهم إنها الأرض الموعودة! يهاجرون أو يدفعون للهجرة إليها من كل جهات الأرض، لا يربطهم لا ثقافة ولا عرق ولا لغة مشتركة، إلا هدف سرقة الأرض وإقامة دولتهم التي وعدهم بها الإنكليز، توحدوا كلهم وراء هذا الهدف رغم أنه لا إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني، تخيل أن اللصوص يا عبد الرحيم يتوحدون على سرقتهم، ونحن أصحابَ الأرض مشغولون بالتشتت والتشرذم وإقامة أحزاب سياسية!».
اللغة
من المقطع السابق والمقطع الافتتاحي، والكثير من مقاطع مطوّلة في الرواية نجد لغة غارقة في كلاسيكيتها، ناهيك من الاستغراق في التشبيهات والألعاب البلاغية المدرسية، التي تعطل الحدث الروائي تماماً، وهو أسلوب تم تجاوزه منذ زمن بعيد. حالة الاستغراق هذه أتخمت العمل لآقصى حد، فحوادثها وحالة الشخصيات وحواراتها دون الغرق البلاغي هذا، سيختصر حجمها إلى أكثر من النصف، بل سيجعلها أكثر تماسكاً وتكثيفاً، خاصة أنها لا تفيد الحدث أو حالة شخوصه، اللهم إلا تهويمات وخيالات بلاغية مكانها كتب الإنشاء المدرسية، للتدريب عليها ثم نسيانها. ولا يمكن الادعاء بأنها لغة ذلك الزمن والتوحد معها، لأنه أمر خارج عن منطق السرد الروائي.
مشكلة التأريخ
استعرض الكاتب عبر صفحات الرواية تفاصيل، وشخوصا وحوادث الثورة الفلسطينية الكبرى، بداية من الشيخ عز الدين القسام، والشيخ فرحان السعدي، والعديد من الشخصيات، كالشاعر إبراهيم طوقان، ونوح إبراهيم الشاعر الشعبي لثورة 1936، وقصيدته الشهيرة «من سجن عكا طلعت جنازة» وقبلها ثورة البراق الشهيرة عام 1929، وكذا شهداء (الثلاثاء الحمراء).. عطا الزير، فؤاد حجازي ومحمد جمجوم، الذين أعدمتهم سلطات الانتداب. وصولاً إلى مقتل القسام نفسه، والخطبة الشهيرة لابنته ميمنة القسام في جامع الاستقلال في حيفا بعد مقتل أبيها، وقد أخرجت مسدساً من حقيبتها قائلة «مَن لا يثأر لأبي سأقتله بهذا المسدس» ثم حركة الاغتيالات الكبرى، التي نفذها رجال القسام، كاقتحام سجن (عتليت) وتحرير الأسرى في يوليو/تموز 1938، واغتيال نائب حاكم منطقة جنين في أغسطس/آب من العام نفسه، واغتيال قادة فصائل السلام، التي شكّلتها بعض الزعامات الإقطاعية بدعم من الإنكليز، وقاتلت ضد الثورة وابنائها.
وبالطبع كلها وقائع معروفة ومذكورة بشخوصها وأحداثها، وما حال البطل هنا إلا للتذكير بها من خلال نسيج روائي، وهو أمر مقبول، وقد يبدو لافتاً عندما يتم السرد ما بين الخيالي والتاريخي. لكن السؤال هنا.. هل نحن بصدد عمل أدبي أم كتاب تاريخ؟ بمعنى إلى أي مدى تحققت أدبية العمل؟ والإجابة متروكة للقارئ.