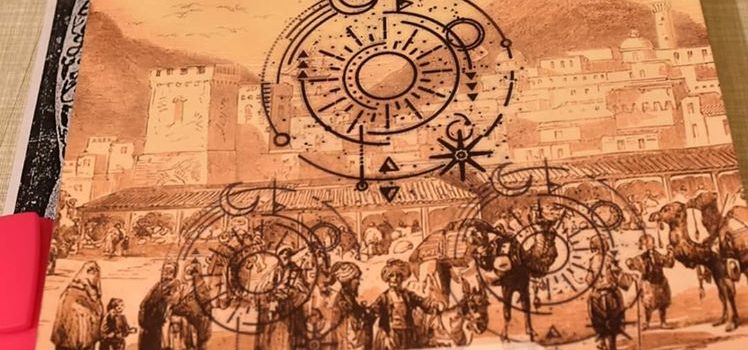محمد علي
انتهيت من قراءة كتاب أعتبره أهم دراسة يمنية صدرت في السنوات الأخيرة. ولي عتب على مؤسسة أروقة بوك على ضعف توزيع كتاب بهذه الأهمية واقتصاره على مقرهم في القاهرة، وأشدد على ضرورة توفيره على مواقع بيع الكتب، ليلتفت إليه الباحثين العرب قبل اليمنيين لما فيه من مباحث أدبية وميثولوجيه في غاية الأهمية، يمكن نقدها والبناء عليها.
ألوهية الحكيم الفلاح في الموروث الشعبي، أو كما سماه المؤلف أحمد العرامي: “ديانة اليمن السرية”.
يناقش الكتاب ظاهرة عجيبة في أرياف اليمن لم أكن أعرف عنها شيئاً، وهي شخصيات حكماء فلاحين يحتكم أهالي القرى إلى أقوالهم ويفضلونها أحياناً على نصوص القرآن الكريم! حتى أن بعض الأهلي يلحقون باسم أحدهم وهو علي ولد زايد، عبارة “صلى الله عليه وسلم” ويعتقدون أنه تعمّر سبعة أعمار، كلما يصبح عجوزاً على عكاز، يعود شاباً في اليوم التالي، وأنه “مش عادي مش مثل كل الناس” وأنه “يعرف متى يهب الجراد ومتى ينزل المطر” وهذا يعني أننا أمام جماعة لم يمس الإسلام تصوراتها العميقة”
لذلك ذهل فقهاء الزيدية إذ وجدوا أنفسهم أمام مجتمع مضى على دخوله الإسلام حوالي 14 قرناً، ومع ذلك عليهم أن يحاربوا فيه ما كان الإسلام يحاربه في قرونه الأولى.
ويرى المؤلف أن من نعرفهم من الحكماء الفلاحين في الثقافة الشفاهية اليوم، ما هم إلا ظلال لآلهة زراعية هبطت إلى مستوى بشري، بينما أقوالهم ليست سوى أصداء لملاحم زراعية دينية، عرفت في اليمن القديم.
وأن أدب الفلاحة اليمنية هو امتداد لأدبيات زراعية سابقة للإسلام، بل وللديانات السماوية، بقيت حية في الثقافة الشفاهية حتى اليوم، ويمكن أن تعد صورة من صور مقاومة الديانات الزراعية القومية للديانات السماوية.
ولا يكتفي الباحث بالمقاربات الميثولوجيا الممتعة مستعيناً باطلاعه الواسع حولها وحول النقوش والآثار اليمنية والموروث الشفاهي الذي جمعته دراسات سابقة بالإضافة للتي جمعها بنفسه من كبار السن، بل إنه يخصص جزء كبير من الكتاب للظواهر الأدبية في محتوى هذا الأقوال والأشعار ذاتها، فصاحبها “هو شاعر لا يقول الشعر إلا حكمة، وحكيم لا يقول الحكمة إلا شعراً” إنه شاعر لا يهجو ولا يمدح ولا يرثي ولا حتى يتغزل، كما اعتدنا أن نرى في مواضيع الشعر الجاهلي في شمال الجزيرة، بل إن الحكيم اليماني يخلص في شعره للحكمة ويقدمها للجماعة، وهذه الجماعة ليست قبيلة أو سلالة، وإنما هي تجمّعٌ جغرافي أو مهنيّ.
فهو أشبه ببطل شعبي جماعي، لكن بطولته تتجلى في القول لا الفعل، وهذا القول هو أناشيد وأحكام اجتماعية زراعية، تحضر في إطار طقسي مغرق في القدم، ما يرجّح أسطورية هذا الحكيم وكونه شخصية إلهية هبطت إلى مستوى بشري، عبر الزمن.
وبعد سلسلة من الاستدلالات الذكية والرشيقة، ينتهي المؤلف إلى أن شخصية الحكيم المسمى “شرقه” في بعض مناطق محافظة البيضاء والمختص برفع مياه الآبار، هو هبوط لشخصية الإله “عثرت شرقن” المختص بالمطر.
وأن شخصية الحكيم “سعد السويني” في حضرموت والمختص بالسقاية، هو هبوط للإله الحضرمي “سين” الذي كانت السقاية إحدى اختصاصاته أيضاً، بل ويجد الباحث علاقة بين تسميته “سعد السويني” وشخص اسمه “ثعد سين” ورد في نقش حضرمي، وأنا أؤكد على فرضيته بحقيقة أن قلب السين ثاء هو أبرز خواص النقوش الحضرمية بالفعل.
ويستمر في بحثه حتى يصل إلى حقيقة لم تكن في الحسبان، وهي علاقة بين الأدب الزراعي اليمني والأدب الزراعي الإغريقي، وتحديداً في قصائد الشاعر الإغريقي هزيود ??????? حيث جمع المؤلف العشرات من الأمثلة للتناص بين الظاهرتين، على مستوى البنية والخطاب والمضمون إلا أن المؤلف لا يتورط بالجزم أيهما أقتبس من الآخر، رغم نقاشه للأصول الشرقية المفترضة للشاعر هزيود، لاسيما والعلاقات اليمنية اليونانية ممتدة إلى ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد.
على ألا يعني ذلك بأي شكل من الأشكال امتداد ظاهرة الحكيم اليماني للظاهرة اليونانية، بل قد يكون الأمر عكس ذلك تماماً، ليس فقط بسبب ما يقال عن شرقية هزيود، ولكن بسبب الأصول الدينية للظاهرة اليمنية.
وبما أن الكتاب قد فتح الباب على مصراعيه على حقل خصيب للدراسات والإمكانات التي يوفرها الموروث الشفاهي في اليمن، وقلّ من يهتم به، فإنه يستمر بطرح مسائل أخرى لعلها أكثر تعقيداً، مثل رمزيات قصة الملكة بلقيس ولقائها بسليمان والعلاقات المفترضة بينها وبين قصة مشابهة التراث الشفاهي اليمني ومعتقداته القديمة، وقضية الصراع القديم بين شمال الجزيرة وجنوبها، وتنافسها على النبوة والمركزية الدينية، وإذا ما كانت نبوة الأسود العنسي آخر ارتعاشات هذا الحلم، فإن حكماء الفلاحة في اليمن ليسوا أقل من بقايا أولئك الملوك اليمنيين الذين فشلوا في التحول إلى أنبياء أو أنصاف آلهة، فتنكروا في ثياب حكماء، مكونين لنا ظاهرة شفاهية مثيرة هي ظاهرة ديانة اليمن السرية.