بيير لارشيه: الفصحى بوصفها اختراعاً
نجم الدين خلف الله*
يسود الاعتقاد أنّ العربيّة “الفُصحى” مُعطًى متعالٍ وُجد بذاته كجوهرٍ، لا يتأثّر بالزّمان والمكان. وهذا الاعتقاد تمثّلٌ (représentation) ثقافيٌّ صاغه العرب المسلمون، على امتداد أجيالٍ، من أجل توصيف ما اعتبروه الشكل الأنقى لكلامهم. إلاّ أنَّ هذا المفهومَ، شأنُه شأن كلّ الابتكارات الإنسانيّة، لم ينزل من السماء وإنما وَلّدَته ظروفٌ اجتماعيّة-سياسيّة حفّت بِصراعاتٍ فكريّة وقوميّةٍ، ولا سيّما في ظلّ الانقسامات العميقة بين العَرب والفرس وغيرهم من المكوّنات الثقافيّة التي تعايشت ضمن حضارة الإسلام في العصر الوسيط. وهو تمثّل جمعيّ وعالِم، يستدعي بواسطته أصحابُهُ، من لُغويّين وفقهاءَ ومفسّرين، ما يعتبرونه المعيار الأعلى لصحّة المعاني وسلامة الألفاظ، نطقًا وتركيبًا ودلالةً.
وللحَفر في السياقات التي نشأ ضمنها مفهوم “الفصحى”، يعود الباحث الفرنسي بيير لارشيه (1948)، في كتابه الأخير “اختراع اللغة الفُصحى، تاريخ العربية من خلال النصوص” (الصادر عن دار بييتر، 2021)، إلى التمثّلات والتصوّرات التي صَنَعها علماء العربية من أجل التحققّ من جُذورها وغاياتها. ولئن أطلق على هذا المسار لفظ “الاختراع” فللتدليل على أنّ المفهوم رُكّب نظريًّا وتطوّر عبر التاريخ.
يثبت المؤلف أن الفصحى مفهوم تطوّر عبر تاريخ طويل
ولذلك، عاد الباحث الفرنسي إلى فئات مختلفة من النصوص: ففي القسم الأول، استنطق أعمال اللغوي- المتكلم، ابن فارس (941-1004م) الذي رَبط الفصاحة بالإعجاز، وجعل نقاءها في خلائها من مَظاهر الضّعف مثل: الكشكشة والكسكسة والإنطاء والعَجرفة. وفي القسم الثاني، استعرض آراء أبي يعلى الفرّاء (990-1066) الذي وصل الفَصاحة بلغة “الأعراب الخُلّص” وأساليب “البداوة”. وأثرى لارشيه مبحثه هذا عبر تحليل كتاب “الحروف” للفيلسوف أبي نصر الفارابي (872-950) الذي ركّز فيه على العربيّة المَكتوبة. ثم طعّم عَرضه بنظرة النحويين، ومن نماذجهم الزجّاجي (892-952) مركزًا على جذور النحو العربي، وابن جِنّي (941-1002)، وختم عَمله بتحليل وصف الاستعمالات العربيّة التي دونها رحّالتان: المُقَدّسي والعَبدري.
تندرج هذه الدراسات، وقد كُتبت على فتراتٍ متباعدة، في ما يكمن أن نطلق عليه “الحفر المعرفي” archéologie والغرض منه العودة إلى الجذور الثقافيّة التي رافَقَت نشأة مفهوم “اللغة الفصحى”، وتطوّره عبر العصور والكتابات وأجناس القول والتنظير. ولا شكّ أنّ هذا المفهوم وثيق الصلة بأسلوب النصّ القرآني الذي اعتُبِر معيار الفصاحة. وقد صاغه مُفكّرو الإسلام من أجل البرهنة على أنّ “لهجة قريش” هي أفصح اللهجات نطقًا، دفاعًا عن عقيدة الإعجاز. وتضعنا هذه العقيدةُ أمام قضيّة حسّاسة وهي العلاقة بين المقدّس واللغويّ وحدود التلامس بينهما.
وستظل هذه القضيّة الشائكة مثار جدل ما لم تُحل مسألة “المقدس”، وبأيّ معنًى يمكن القول بقدسيّة كلامٍ ما؟ ومن المشروع أن ينافح هؤلاء اللغويون، والذين كانوا أيضًا علماء كلام وفقهاء، عن إعجاز القرآن وعن إلهيّة مَصدره. وليس خافيًا القول بتأثير المعتقد الدينيّ في التصورات اللغويّة والبلاغيّة والنحويّة العربيّة. لذلك، يعود لارشيه، ضمن منظور نقديّ، إلى تبريرات القدامى الواقعة بين مطرقة الدّين وسندان المعطيات اللغويّة ولاسيما إلى الدواعي التي جَعلتهم يرفعون “لهجة” قريش إلى مصافّ الأنموذج المتعالي لفصاحة اللهجات، ويقابل بين الطرح الديني وهو المحكوم بنظريّة الإعجاز القرآن القائم على فصاحة الحروف والكلمات وخلوّها مما يشوبها، كما أثبته الجرجاني والزركشي والسيوطي، وبين التصوّر اللغوي، وهو ما حدا بالفرّاء إلى اقتراح مبدأ “التخيّر”، أيْ إنّ قريش كانت تنتقي أنقى الكلمات التي تسمعها من قبائل الجزيرة التي تحجّ البيتَ حتى استوى لها لسان مُتَخَيّر.
أثّر المعتقد الدينيّ في التصوّرات اللغويّة العربية
وبهذا المعنى، اعتبر الباحث أنّ “الفصحى” إنشاء أو اختراعٌ أيديولوجي، كان الهدف منه إعلاء سلطان الدّين وإثبات أفضليّة قريش. ولكي يَفرض القرآن ذاته مرجعًا للأمة لا بد وأن يكون في الدرجة العليا من البَيان والكمال.
وهكذا فالكتاب بحث استقصائيّ من خلال النّصوص التي نظّرت لمَفهوم الفصحى ومعالجة ما تخفيه من صراعاتٍ وتجاذبات، ولا سيما حركة الشعوبيّة، التي جَعلت العَرب يفتخرون بمقوّمِ هويتهم الأساسي، اللغة الفصحى، ويرون فيها أصفى المقوّمات في مواجهة الثقافات الأخرى، كالفارسية والتركية والأرديّة التي تعايشت في ظلّ الخلافة العباسيّة، وفي مواجهة اللهجات الإقليميّة التي بدأت في الانتشار، حتى جعل منها الجاحظ محلّ سخريته.
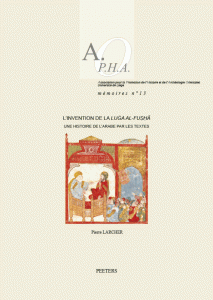
وما يُؤخذ من مثل هذه الأعمال ليست النتائج التفصيليّة ولا المعلومات الفرعيّة الخاصة بكلّ فصلٍ، وإنما الرّوح النقدية للتّراث اللغويّ ومنهج محاورة النصوص كأدب الرحلة ودواوين الفقه وعلم الكلام، حيث كان المشغل اللسانيّ حاضرًا، ضمن النقاشات المجتمعيّة التي تناولت إعجازَ القرآن وحدوثَه أو قدمه من أجل الخوض في قضايا العدالة الاجتماعيّة وشرعيّة الخلافة وأحقيّة الخروج عن السلطان…
ولا تقاس قيمة هذا الكتاب بما تضمّنه من أفكار جديدة، وإنما بصرامة منهجه العلمي الذي استقصى طبقات المفهوم وحفر فيها حتى الجذور، ولا سيما وأنه خاض في أجناسٍ مختلفة من الأقاويل تراوحت بين كتب لغةٍ وأدب الرّحلة وتنظيرات الفلاسفة، مما يقدم نظرة شاملة عن مفهوم “الفصحى” الذي حَكم، في العصر الحديث، العديد من القرارات السياسيّة، كما غذّى الخطاب القوميّ وما تفرّع عنه من إيديولوجياتٍ.
ولا بد من التنويه ختامًا بلغة لارشيه الدقيقة “الفصيحة”، فكأنّما توارث أسلوب النحاة والبلغاء الذين يشتغل على مدوناتهم دقةً ووضوحًا، مع اطّلاع واسعٍ على التراث اللغويّ العربيّ، وعلى ما أنجزه المستشرقون والمستعربون، طيلةَ القرنَيْن الماضِيَيْن، من أبحاث، غثّها وسمينها، سلّطَ الضوء على تناقضاتها، وهذا هو المعنى الدقيق للنّظر النقدي.
ولا شك أنّ المكتبة العربية ستثرى بترجمة هذا الكتاب، ليس لما تضمنه من معلومات فهي شائعة، ولكن لتطبيق الحسّ النقديّ على مفهوم حسّاسٍ، يشكّل في المخيال الجمعي، ما يشبه الطابو (المحظور) الذي لا تجوز مساءلته، بعد أن غدا مُقدّسًا تحيط به هالات الغموض، مع أنه مفهوم اختَرَعه البَشر، ليعكسوا به تطلّعاتهم وصراعاتهم وليوظفوه في تأويل النصّ القرآني. ولا حرج في استنطاق نصوص مشابهة لدى علماء آخرين، حتى يتوسّع البحث عن مفهوم الفصحى في مختلف مجالات التفكير والتعبير لتَكتمل الصورة التاريخيّة عن نشأة “الفصحى”.
أعمال الباحث الفرنسي بيير لارشيه مجهولة نسبيًّا لدى الجمهور العريض من القرّاء العرب، مع أنّه قدّم، طيلة العقود الأربعة الماضية، عشرات الدّراسات والكتب التي حلّلت المُدوّنة اللغوية ووَصفت نِظام اشتغال الضاد سواءً من خلال دراسة الأفعال والأسماء والاشتقاق، أو البحث في آليات الدلالة النحويّة والبلاغيّة، مع اهتمام واضحٍ بعلوم القرآن. وكلّ ذلك في نفس علمي دقيقٍ. ولعلّ هذا النفس هو ما تتوجّب ترجمتُه.
- كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس



Comments are closed.