غربة الفلاسفة والشعراء!
عزيز الحدادي*
على الرغم من أن الإنسان يحيا شعريا على هذه الأرض، فإنه يظل غريبا، موجودا غريبا في الأرض، ولذلك يكون قدره هو البحث عن الأصدقاء، فالغريب هو الآخر بالنسبة للآخرين، إنه في رحلة نحو ذاته، يرحل، يتجه في طريقه إلى المكان الذي ينتظره، يبحث عن السعادة بواسطة التيه، فخطاه تشبه خطى الغريب، لكن أين يتجه الغريب عادة؟ هل هو مدعو إلى الشهادة على أنه روح؟ وماذا يعني أنه يحيا شعريا على هذه الأرض؟
في كتاب مشترك بين الفيلسوف والشاعر تمنح لنا الفلسفة معنى الانسان في القصيدة: «إنه هبة الأعماق التي تسود في كل حضور، وحدة الانتشاء بين التراجديا والملحمة، إنهما شعلة الروح، ما أجمل هبة الأعماق، أي النفس التي تمنح النفس عظمتها، كألم، هي التي تحيي، لأن النفس عبر هذه الهبة، هي التي تمنح الحياة».
الفيلسوف والشاعر، يبدأ وجودهما من الألم، ولذلك فإن الفيلسوف مجرد تائه غريب، والشاعر أيضا غريب، فهما مولعان بعضهما ببعض ولو في سكينة الليل، وما يميز هذا الليل هو زرقته التي تقود نحو الأفول، ولكن أي أفول؟ إنه الجرح الأعمق غورا في الجنس البشري، الذي جعل من الاغتراب سكنى للروح، وترك النفس تتألم متشوقة إلى الرحيل، خاصة أنها تتذكر وجودها الميتافيزيقي، الوجود الأعظم بالمعرفة والسعادة، وليس عبثا أن النفس، حيث تسكن في روح الشاعر تؤسس الأبدية، وفي روح الفيلسوف الوجود والزمان.ما يدوم يؤسسه الشعراء، لأن الشعر، حسب هايدغر، هو تأسيس للوجود بواسطة اللغة، والفيلسوف هو المنقب الجيد في جوهر الشعر: الشاعر والفيلسوف من هما؟ وكيف كانت علاقتهما؟ بل وما مصيرهما في هذا العالم؟ ولماذا طرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته، واحتفل بهم هايدغر في كتاباته؟
في أعماق هذه الأسئلة الجوهرية، ينمو الفكر، الذي يفكر بقوة في عصره، انطلاقا من الإنصات إلى نداء الروح والوجود، ذلك أن الوجود شعريا في عمق أعماقه، والروح تحيا شعريا على هذه الأرض، فثمة حقيقة خضعت للنسيان في هذا العالم المضطرب بالحروب والوباء، وهي التي تقول إن وجود الإنسان في العالم لا يمكن أن يكون جوهريا إلا إذا كان شعريا في أعماقه: «لأن الشعر هو الذي يبادر إلى جعل اللغة ممكنة» واللغة هي مسكن الوجود.
بيد أن الانسان هو راعي الوجود، ولا يستطيع أن يتعرف على مسكنه سوى بجوهر اللغة، باعتبارها جوهرا للشعر، ولذلك أصبحت اللغة نعمة للإنسان، والشعر أكثر المشاغل براءة، ومن خلاله يقاوم الزمن الممزق الكينونة بين الحاضر والماضي والمستقبل، هكذا نستطيع أن نفهم ما معنى الإنسان، أي الفلسفة والشعر، وإلا كيف يمكن تأسيس الأبدية في غيابهما؟ بل كيف كانت ستكون الحياة على هذه الأرض بدون فلسفة وشعر؟ وكيف أصبحت جمهورية أفلاطون بدون شعراء؟ لم يتردد سقراط في طرده لشعراء التراجيديا من جمهوريته، معللا ذلك بقوله إنهم يفسدون أخلاق الشباب، بيد أن تناقض الخطاب السقراطي بين الكتاب الثالث من الجمهورية، حيث كان اختلافه ميتافيزيقيا: الوهم والحقيقة، ولذلك يتعين علينا صياغة هذا الطرد السقراطي للشعراء في سؤال النقد، كما دفعنا عنه على امتداد هذا الكتاب، بمعنى النقد كشرط لقيام المعرفة، وبلغة كانط: «النقد هو الذي يقرر إمكان قيام الميتافيزيقا، أو استحالته» ومن أجل قيام الميتافيزيقا السقراطية، ينبغي إبراز الأوهام والمغالطات التي يحلم بها الشعر التراجيدي، نقد سلطة الشعراء، وتأسيس سلطة الفلاسفة، ولذلك سنقدم قراءة نقدية لهذه الميتافيزيقا التي رفضت الشعر، وحرمت الروح من الإقامة الشعرية على هذه الأرض. فجدل العقل ممتع، لأنه يسمو بالروح إلى أصل الوجود، ولا يمكن أن نرتقي إلى هذا الأصل إلا بالحوار، كما أسسه سقراط، أضحى الحوار هو الفلسفة، باعتبارها ميتافيزيقا ضد الشعر التراجيدي، ولكن كيف كان هذا الدفاع ممكنا؟
لم يكن نيتشه مقتنعا بهذا الاختلاف في الوجود والمعنى، لأن وحدة الموضوع لا تعني وحدة النظر، على الرغم من ان الغاية تظل واحدة «فالشعراء كثيرا ما يكذبون، وهل كان زرادشت إلا واحدا من هؤلاء الشعراء» بل إنه يذهب إلى حدود القول «نحن الشعراء نكذب كثيرا ولا بد لنا من الكذب مادام ما نجد في العالم قليلا».
وفي الحقيقة أن سقراط يضع الشعراء أمام خيار مستحيل، إما أن يتوقفوا عن كتابة الشعر، وإما أن يتم طردهم من مدينته الفاضلة «وهكذا يتعين علينا، يكتب سقراط، أن نتوجه مرة أخرى برجاء إلى هوميروس وغيره من الشعراء، ألا يصوروا أخيل على أنه ينام تارة على جنبه وتارة أخرى على ظهره، وتارة ثالثة على شاطئ البحر، وفي نفسه ألم عميق لا يخفف منه شيء». كما أن سقراط ينتقد الشعراء الذين لا يرون في الحياة أطيب من «موائد حفلت بالخبز واللحم، وندمان يمرون بالنبيذ الذي يسكبونه من آنية إلى الأقداح، فهل تظن أن الشباب يتعلم الاعتدال بسماع هذا؟».
وبما أن الكتاب الثالث من الجمهورية كان يسعى إلى تقديم نظرية في التربية، فإن جل الانتقادات توجهت إلى هذه الحياة الباذخة التي يروج لها هوميروس وجماعته.
بيد أن الكتاب العاشر الذي جعل من النقد أداة للميتافيزيقا، من أجل الدفاع عن سياسة الحقيقة، سيغير استراتيجية الحوار، حيث نجد سقراط يدعو إلى حظر الشعر من جمهوريته، انطلاقا من قاعدة أساسية «تلك التي تنص على حظر الشعر القائم على المحاكاة.. أصرح برأيي هذا لكم سرا، إذ أنكم لن تشوا بي لدى شعراء التراجيديا وبقية الشعراء، الذين تقوم أعمالهم على المحاكاة، فيبدو لي أن هذا النوع من الشعر يؤذي الأذهان التي تسمعه» فكيف يمكن الانتقال من الدعوة إلى نقد الإفراط في اللذة الذي يدمر التربية، إلى نقد المحاكاة التي تهدم الحقيقة، باعتبارها مسكنا للميتافيزيقا؟ ألا يكون هذا الفصل بين اللذة والمحاكاة مجرد فصل منهجي يسعى إلى تفكيك بنية الشعر التراجيدي؟ ألم يكن سقراط مترددا وخجولا من شاعر الشعراء هوميروس؟
من الواجب أن لا نحترم إنسانا أكثر مما نحترم الحقيقة، بهذه الحكمة الرائعة يعتذر سقراط من هوميروس «الذي يبدو أنه كان المعلم والمرشد الأصلي لكل هذه المجموعة الرائعة من شعراء التراجيديا». الواقع أن هوميروس كان عزيزا على قلب سقراط، لكن الحقيقة أعز عليه من هوميروس، والحقيقة، لا توجد إلا بين الأرض والسماء، ولا يحلم بها إلا الشعراء والفلاسفة، بيد أن حقيقة الشعراء ليست هي نفسها حقيقة الفلاسفة، فالحقيقة في القصيدة استيطيقية، وفي التأملات الفلسفية برهانية.
لم يكن نيتشه مقتنعا بهذا الاختلاف في الوجود والمعنى، لأن وحدة الموضوع لا تعني وحدة النظر، على الرغم من ان الغاية تظل واحدة «فالشعراء كثيرا ما يكذبون، وهل كان زرادشت إلا واحدا من هؤلاء الشعراء» بل إنه يذهب إلى حدود القول «نحن الشعراء نكذب كثيرا ولا بد لنا من الكذب مادام ما نجد في العالم قليلا». ولعل هولدرلين عبّر عن ذلك قائلا «الشعر هو الشاغل الأكثر براءة من بين المشاغل كافة، إنه بمثابة حلم، ولكنه يتطلب أخطر الملكات لمواجهة سحر اللغة.
كاتب مغربي


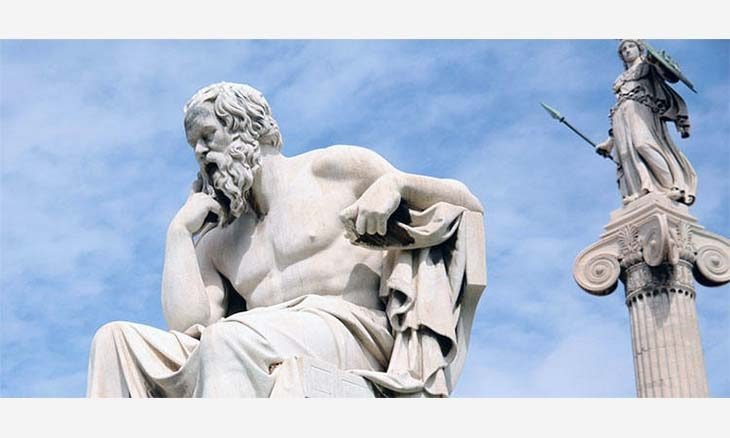
Comments are closed.