“رأيت رام الله” لمريد البرغوثي: أوجاع الفلسطيني الذي رأى
عبداللطيف الوراري*
تكاد المفارقة تصبح سمة العمل الحديث الأساسية، وهي صيغة من الخطاب تتضمّن رؤية للعالم خلافية ودرامية في الغالب، تعني قول المرء نقيض ما يعنيه، أو أن تقول شيئًا وتقصد غيره. إنّها فنّ، وموقف، ورؤية، ثُمّ هي أسلوب قول الشيء على غير وجهة حقيقته من جهة، والإيحاء بمعنى مناقض ومُبطّن يكون، بطريقة ضمنيّةٍ وغير مباشرةٍ، هو المقصود به والمعوَّل عليه من جهة أخرى، فيترتّب على ذلك تفجير الوحدات الدلالية، ونقض سكونيّتها من داخل العمل نفسه؛ ومن ثمة خلق دلالات متعددة ومستفزة في نفس القارئ، قد تبدو في ظاهرها متناقضة غير أنها بعد إمعان النظر تبدو كأنها تحوز قَدْرًا من الحقيقة.
تأخذ المفارقة في الأعمال ذات الطابع السيرذاتي وضعًا إشكاليًّا خاصًّا، بحكم أن بنيتها مُباينةٌ، شكلًا ومعنىً، لنص السيرة الذاتية ونظامها الأنواعي. ولهذا، ينبع عنصر المفارقة من البنية العميقة للنص، وينتعش من تداخل السردي والشعري باعتبارهما بنيتين متقابلتين، ويشمل مُكوّنات دالّة في العمل السيرذاتي، بما في ذلك بنية اللغة والفضاء. وكلّ مكوّنٍ من هذين العنصرين، أو من غيرهما من العناصر البانية، يخلق نمطًا خاصًّا من المفارقة، يعبّر عن طابع غنائي وعاطفي لدى الذات، أو عن وعي حادّ وخلافي له بنفسها وبالأشياء التي حواليها، على نحو يكشف جملة التناقضات في تسريدها للعالم، رؤيةً وتعبيرًا وحساسيةً.
سياسات العين اللاقطة
ابتداءً من عنوان العمل «رأيت رام الله» (منشورات المركز الثقافي العربي)، يشعُّ عنصر المفارقة، لأنّ فعل الرؤية لا يتمّ لأول مرة، بل بعد عودة الكاتب مريد البرغوثي إلى مسقط رأسه رام الله، وغيبته عنه في منفىً قسريٍّ دام ثلاثين سنة؛ وكأنّ الفعل الذي تحقق قد أشبع مشاعر اللهفة والشوق والحنين في نفسه؛ ولكنها ليست أي رؤية، بل هي رؤية مُفارقة: «غَبشٌ شامِلٌ يغلّل ما أراه، وما أتوقعه، وما أتذكّره»؛ وإذاك هي رؤية تمتزج فيها أفعال من الكلام متنوعة ومتعارضة تُعبّر عن إعادة اكتشاف من جهة، وعن سخط الرائي وعدم رضاه ممّا رآه وعاينه في مدينة محاصرة، بالكاد تتغيّر من جهة أخرى. فهو من الجسر تبدو له «الأرض المحتلّة» ويراها قريبةً ملموسةً وموجودةً بحقّ، تتمتّع بكل وضوح التربة والحصى والتلال والصخور، و«ليست وهمًا في آخر الدنيا، ليست مجرّد عبارة في نشرات الأنباء». وبالتالي، يمكن تأويل ملفوظ العنوان بـ(تأثّرتُ لرام الله بعد رؤيتها). بين الرؤيتين الأولى والثانية تاريخ آخر، وولادة أخرى.
وبما أن المفارقة لا تنبع من تأمُّلات راسخة ومستقرة في النفس، وإنّما هي تصدر أساسًا عن ذهن متوقّد، ووعي شديد للذّات بما حولها، فقد استطاع مريد البرغوثي بما هو شاعر يتمتّع بتلك الروح الشفّافة، والبصيرة النافذة والعين اللاقطة والساخرة، أن يجعل من المفارقة في عمله السيرذاتي بمثابة استراتيجية خطابية. وقد أثبت إدوار سعيد ذلك في تقديمه للعمل، ومن جملة ما قاله: «إن عظمة وقوة وطزاجة كتاب مريد البرغوثي، تكمن في أنه يسجل بشكل دقيق موجع هذا المزيج العاطفي كاملًا، وفي قدرته على أن يمنح وضوحًا وصفاءً لدوامة من الأحاسيس والأفكار التي تسيطر على المرء في مثل هذه الحالات».
ومنذ العنوان الأول (الجسر)، يتجلى عنصر المفارقة في ملفوظات تتّصل بالذات واللغة والسياسة، ومن ثمّة تعكس مظاهر العزلة والتناقض والتضاد والعبث التي تطغى على الحياة في الجسر، ويشعر بها أنا السارد بقدر ما يتألّم ويسخر منها. وهو يخاطب الجسر، يتحدث إليه بصفته المحسوسة والمادّية المبتذلة، من حيث أخشابه ومساميره وإسفلته، وكونه ضيّقًا لا ماء يجري تحته؛ لكن سرعان ما يرتقي به إلى جسرٍ آخر، خياليٍّ ومفارق. يتحوّل الجسر إلى صورة بلاغية، إلى موتيف يخلق مع الوقت تجربة عبور مليئة بالمشاعر المتناقضة، التي كانت تنتاب أنا السارد. جسر مُعلّق بين الجانب الأردني و(الجانب الآخر). يقول: «ها أنا أمشي بحقيبتي الصغيرة على الجسر، الذي لا يزيد طوله عن بضعة أمتار من الخشب، وثلاثين عامًا من الغربة. كيف استطاعت هذه القطعة الخشبية الداكنة أن تقصي أُمّةً بأكملها عن أحلامها؟ أن تمنع أجيالًا بأكملها من تناول قهوتها في بيوتٍ كانت لها». في نسيج الملفوظ ثمّة نقد مُبطّن ولاذع وساخر لتاريخ الخسارة والهزائم المتلاحقة؛ إذ ليس العيب في الخشب الذي هو من صُنْع نجّارين تعساء، بل في الشتات الفلسطيني وفي العجز العربي عن اجتيازه.
من هنا، فإن مريد البرغوثي بدلًا من أن يلقي خطبًا تحريضية وحماسية رنّانة ضدّ الجميع، فلسطينيين وعربًا وإسرائيليين، يترك لخطاب المفارقة أن يخلق التوتُّر الدلالي في بنية العمل عبر التضادّ في الأشياء، الذي قد لا يأتي فقط من خلال الكلمات والعبارات المجازية المثيرة والمروعة في السياق، بل عبر خلق الإمكانيات البارعة في توظيف مفردات اللغة العادية واليومية داخل الخطاب «خذ شنطتك واقطع المَيّ. خَلَصْ. لا أقول لك شكرًا أيها الجسر الصغير. الخشب يطقطق، إلخ».
من ملفوظٍ إلى آخر أكثر إيلامًا، لا تكفُّ المفارقة عن تكثيف محكيِّ الذات المتلفِّظة عندما تتشابك مع محكيّات ذوات أخرى، فلا يكون للحكاية الفلسطينية من معنى وقيمة إلا بهذا التذاوت، بلا مطلق ولا متعاليات.
ولما يرى الساردُ الجنديَّ الإسرائيلي يجد أن بندقيّته شديدة اللمعان، أطول منه للمرة الأولى، ساخرًا بقوله: «بندقيّته هي تاريخي الشخصيّ. هي تاريخ غربتي. بندقيته هي التي أخذت منا أرض القصيدة وتركت لنا قصيدة الأرض. في قبضته تراب. وفي قبضتنا سراب». فهو يشعر بأنّه يمتحن إنسانيته الفردية بقدر ما يعلم عن لا إنسانية وظيفته كجندي احتلال يمرّ تحت ظلّ بندقيته الفلسطينيون أحياء وموتى. وتجسيدًا لموقف الذات تحت تأثير الغربة في مواجهة آخرها (العدوّ)، يتكئ السارد في بنية نصّه على المفارقة الدرامية المؤلمة في مشهدين متراكبين: مشهدِ علاقته بالجندي الإسرائيلي الذي «يقف بين عَلَمَيْن إسرائيليين يُحرّكهما الهواء والشرعية الدولية»، ومشهدٍ يتخيّل فيه الشهداء (الجدة، الأب، الأخ منيف، غسان كنفاني، ناجي العلي..) وهم يدخلون عليه غرفة الانتظار، وكأنّه يداري نفسه، ويتخلى عن ألمه الشخصيّ ليوحي إلينا بمأساة وطن بأكمله فقد الكثير من أبنائه، شاعرًا بهم «كأنّها أيقونات أندريه روبليي» تومض في عتمة المعابد النائية في القرن الثالث عشر».
حكمة الخسارات
عندما يتخطّى مريد البرغوثي الجسر يشعر كأنّه تخطّى حاجزًا في الجغرافيا، وحاجزًا في المشاعر، وحاجزًا في الوجدان، تاركًا عالمًا ومستقبلًا عالمًا آخر. في هذه الأثناء، تعمل الرؤية المفارقة عبر طزاجة اللغة في العمل تلقائيًّا تحت الشعور بالغربة، والخيبة ممّا يحدث واللهفة لاحتضان الأرض والأهل. وفي ظلّ اتفاقيات أوسلو ومفاوضات عملية السلام التي لا تنتهي، ما زال يُنبّه إلى المفارقة الصارخة على الأرض، فالإسرائيليون هم الذين يمسكون بزمام الأمور، ويعطون التعليمات بالدخول والخروج من على الجسر، فيما الضابط الفلسطيني لا يستطيع مع هذا الوضع غير المتكافئ أن يُقرّر شيئًا. كما أنّ الأعلام الإسرائيلية تغشى سماء الأرض المحتلة، بل الأدهى أن يجري اختلاق مفردات جديدة نتجت عن اغتصاب اللغة وفصلها عن سياقها الحقيقي، كأن يتمّ إعادة تسمية العدو الإسرائيلي بـ(الجانب الآخر). وفي هذا السياق، يقول مريد: «نجحت إسرائيل في نزع القداسة عن قضية فلسطين، لتتحوّل، كما هي الآن، إلى مجرد «إجراءات» و»جداول زمنية» لا يحترمها عادةً إلا الطرف الأطرف الأضعف في الصراع».
لذلك، فإنّ منشأ المفارقة التي تطبع محكيّ الأحداث وتُغذّيه بطابع الصراع غير المتكافئ يرجع إلى قوّة قاهرة ومعادية، هي قوّة الاحتلال الاسرائيلي. إنّ ما حدث في حرب الـ67، أو ما عرف بالنكسة، كان نقطة التحول الكبرى في الصراع مع سارق الأرض؛ وجميع ما جاء بعد هذا التاريخ كان تنازلاتٍ وشروطًا مُهينة ودراماتيكية يتكيّف معها فلسطينيُّو الداخل والخارج، ممّن يحملون تصاريح الزيارة أو لمّ الشمل: «الاحتلال الطويل استطاع أن يحوّلنا من أبناء «فلسطين» إلى أبناء «فكرة فلسطين»».
وقد تولّت عناوين العمل الثمانية الموالية (هنا رام الله، دير غسّانة، الساحة، الإقامة في الوقت، عمو بابا، غربات، لمّ الشمل، يوم القيامة اليوميّ) الإفصاحَ، بطريقة تمزج بين السرد والشعر وتحت وطء حكمة الخسارة، عن تكاليف هذا التاريخ المفارق المؤذية في قصص الآخرين من مثل منيف وأم طلال وأم عدلي. وأخطر أشكال الإيذاء أن تتوقف صيغ الحياة في انتظار الحلّ، كما في قول السارد: «منذ الـ 67 وكلّ ما نفعله مؤقّت و»إلى أن تتضح الأمور». والأمور لم تتضح حتى الآن بعد ثلاثين سنة».
على الرغم من آلة التشويه التي يمارسها الاحتلال في سلوك الإنسان، وعلى واقع الأرض بأعلامه ومستوطناته، فإنّ ثمة إصرارًا من سارد التغريبة الفلسطينية على بقاء حسّ الآدمية ينبض بين التفاصيل ويوميّات الحياة التي يسردها، مازجًا بين الشخصي والعام، وبين الشعري والنثري العامّي على نحو يُشيّد سياسات صورة الفلسطيني، وهو يقاوم الاحتلال بلامبالاته وانصرافه إلى شؤون يومه، كأنّ لا شيء يحدث، وقد حدث. ويظهر مثل هذا الشعور العامّ في الملفوظ التالي: «هنا موضع المرمرة والشقاء اليومي لآلاف البشر من الفلسطينيين طوال سنوات احتلال رام الله. ما زالت مشاكلهم عالقةً ومتشعّبةً وصعبة الحلّ، لكنهم، الآن، يجدون ابتسامةً تستقبلهم في المكان الذي شهد محاولات إذلالهم منذ 1967. لم تكن الحياةُ نَعيمًا قبل الاحتلال الإسرائيلي – كنا نتدبر أمورنا على طريقتنا، يقول لك الجميع. ويضيف الواحد منهم: لكنّ الاحتلال! ويسكت».
من ملفوظٍ إلى آخر أكثر إيلامًا، لا تكفُّ المفارقة عن تكثيف محكيِّ الذات المتلفِّظة عندما تتشابك مع محكيّات ذوات أخرى، فلا يكون للحكاية الفلسطينية من معنى وقيمة إلا بهذا التذاوت، بلا مطلق ولا متعاليات. يقول مريد في علاقة ذلك بتطوُّر تجربته الشعرية: «إنّني كشاعر لم أكن مُقْنعًا أمام نفسي إلا عندما اكتشفْتُ بهتان المجرّد والمطلق، واكتشفْتُ دقّةَ المُجسّد وصدق الحواس الخمس، ونعمة حاسة العين تحديدًا، بذلْتُ جهدًا كان لا بُدّ من بذله من أجل التخلُّص من قصيدة المجاراة من سهولة النشيد. ومن رداءة البدايات».
وعلى هذا النحو من التيقُّظ الدائم ومجاراة الأمل العضال، يظلّ العمل الأدبي الفلسطيني شعرًا ونثرًا، أو الفنّي بوجه عامّ، أحد المغانم الحقيقيّة التي اكتسبتها الأرض المحتلّة من أبنائها الأحرار، وأحد صور الحقيقة الضائعة التي لم ترتَقِ إليها عدالتنا، وتسامحنا، ووجداننا كبشر، مع ما يتطلّبه الأمر لأجل تحرّيها والكشف عنها من عمل الاستعارة في ليالي العبث والمنحدرات السحيقة.
- شاعر مغربي


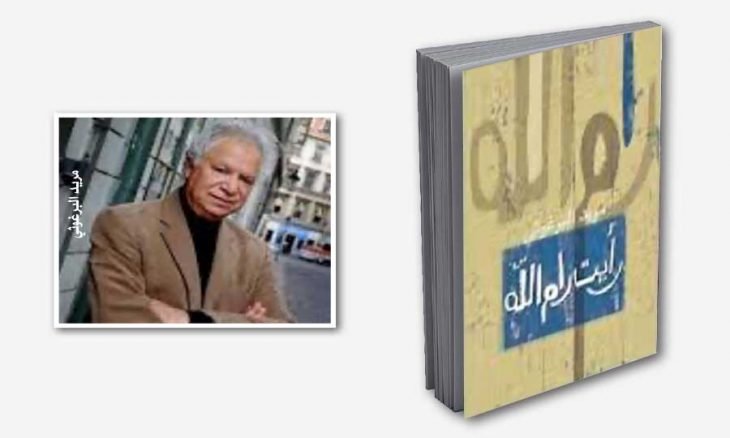
Comments are closed.